بقلم : د. أنطوان سيف
 “وطني شيئان: جمالُ الطبيعة والحرية. فإذا فُقدا، لا يبقى لي وطن” (ص 72). تلكلمُ الكلماتُ المفاتيح لمغامرة العبور إلى خضمِّ دلالات الأعماق غيرِ المرئية التي اتَّخذت الروايةُ، بمعنى السرد، أداتَها. مقولتان محوريتان لا تنفك عن وقائع الخراب والاستبداد اللذين يدفعان تهديد الحياة إلى حدهما الأقصى.
“وطني شيئان: جمالُ الطبيعة والحرية. فإذا فُقدا، لا يبقى لي وطن” (ص 72). تلكلمُ الكلماتُ المفاتيح لمغامرة العبور إلى خضمِّ دلالات الأعماق غيرِ المرئية التي اتَّخذت الروايةُ، بمعنى السرد، أداتَها. مقولتان محوريتان لا تنفك عن وقائع الخراب والاستبداد اللذين يدفعان تهديد الحياة إلى حدهما الأقصى.
“هذه وردة حرّية الروح”، قال عنها مؤلفُها. ولكنَّ عنوان الرواية، مع ذلك، لا يرفع الابهام لأنَّ “حاملَ الوردة الأرجوانية” هو، في الأصل، اسمٌ مستعار يرمي إلى تمويه الهوّية الشخصيَّة لحمايتها. نوعٌ من المقاومة السلبية للاستبداد الذي حينما تحرمه جزءاً من جشعه إلى معرفة أسرار الناس وتوقهم العارم إلى الحرّية الذي يرعبه ويهدِّد سلطته، تكون جررتَه إلى ساحِ معركةٍ لا يتقن تقنياتِها الذكيَّة التي تبتدعها لغةُ العشاق الحميمة وتجعلها عاصيةً على على كل تلصُّص واقتحام من “العيون” الحجرية. تلك المقاومة التي اختارت لغتها بتأنٍّ، وسوَّرتْها بهيروغليفيَّتها الطاردةِ لكل دخيل، والمتحجِّبةَ بالصمت عن اللغة العادية في الاحتجاج والرفض، هي الحدود القصوى التي دونها يغدو الحيادُ الظاهر، أو العزلة المختارة، استسلاماً وتواطؤًا. ليس للمستبدِّ أن يتذرَّع بحقيقةٍ لممارسة استبداده. فنحن نستدرجه إلى طغيانه حين نكثّف في سلوكنا تمويهَ بدعِ عشقنا للحرية وتعميةَ أفعالها! إلاّ أنَّ جمال الطبيعة والحرِّية، عندما نجعلهما صنوَ الوطن وهوّيتَه الحصرية، قد ننزلق، عند تعرُّضِهما، إلى التنازل للقبولِ بأوطانٍ أخرى بديلة هي، في الواقع العام، أكثر حريةً وأكثر حدبًا على البيئة! الشطحُ في هذا التوجُّس المحتمَل، والذي نخشى احتمالَه، يخبو حكمًا ويخفت حين نتذكَّر بأن الوطن نادراً ما يومِضُ في الوجدان بغير مثالٍ أعلى. فهو إضاءةٌ لقتل ظلام معمَّم، جرحٌ في أفئدة تقرِّبها وتوحِّدها المعاناةُ المشتركة ، وفي المقام الأخير شوقُ الجماعة البشرية وتوقها الدائمان.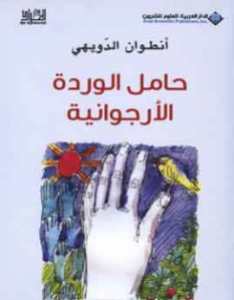
أنطوان الدويهي المهجوس بالحرية لا يني يقوم بأبنيةٍ فكريةٍ فنيةٍ إبداعيةٍ، روايتُه هي إحداها، لجعلها سلوكاً نحياه جميعًا، ولمصالحتنا مع التاريخ، تاريخِنا. واحدةٌ من قممها العملية، وأكثرها بياناً وإطلالةً وليس أوحدَها، كان مشروعَه الانجاز بعنوان: “أربعة قرون من تاريخ الحرّية في لبنان” ضمَّه كتابٌ جماعي التأليف والهوى، قد يكون الأجملَ والأضخمَ الأغنى الذي خرج يومًا من المطابع اللبنانية، والأغلى ثمناً أيضاً، على الاطلاق!
ها نحن إذاً، مع بطل هذه الرواية، بإزاء إحدى ضحايا هذه الحرية، المعتقل في “حصن الميناء”. من غير معرفته بالسبب المباشر لاعتقاله الذي سيتكفل سياقُ الرواية بالكشف عنه.
وإذ مهمَّة مديرِ الندوة ومقدِّمِها، الذي أتبوأُ دورَه ههنا، لا تبيح تجاوزَ الوقت المقتَّر المخصص لمداخلته، سأكتفي – مع المعذرة – بعرض بعض الملاحظات حول نهج الرواية وأسلوبها، وحول مضمونها وأبعاده.
– التماهي بين المؤلف والراوي، وأن غيرُ معلَن، بائن واضح ويصعب فك أواصره: وهكذا تندرج “الرواية” تلقاءً في نوع “السيرة الذاتية” عموماً، سيرةٍ يميِّزها عن سواها في هذا المقام (إذ كل الروايات هي، بشكلٍ ما، سيرةٌ ذاتية مموَّهة “بموضوعيةٍ” شكليةٍ متوهَّمةِ المضمون. ولا ننسى، هنا، عبارة فلوبير الشهيرة: “مدام بوفاري هي أنا”!) هي محوريةُ الراوي (وهو من غير اسم) في سرده، بسيرةِ تاء المتكلمِ الأنوي، وتحرُّكُ شخصيات الرواية جميعها، وهي قليلة، بالنسبة إليه وحده، إنْ مباشرةً ومواجهةً، أم عبرَ التذكُّر! كما ينزُّ المضمون بوفرٍ من الافعال والأشياءِ الخاصة التي لا يخفى انتماؤها إلى سيرة المؤلف نفسه. هذا لا يقتل الرواية، بل يعزِّز حضورها الطاغي بهذه الهوّية الأدبية الراقية التي اختارت نبضَ “الحياة الداخلية” حيث التذكُّرُ والمخيالُ وصخبُ المشاعر العنيفة والرواقيةِ بصمتها، تتداخل “على غرار أشعة شمسٍ غاربة”، بحسب قول برغسون؛ أو، توارُدًا، كـ “شمس الأصيل” ، كما في أغنية رياض السنباطي.
– إلا أنَّ المؤلف، إذ يعتمد الافشاء في بعض الأعلام، أسماء الأمكنة بخاصةٍ دون الأشخاص المعروفين والمشهورين، فإنه يموِّه ذكر أسماء أخرى، ويخفيها؛ مثال ذلك، لبنان (أصبح “الإمارة”، أي كنيته، أو اسمه الناقص الدالّ على مرحلةٍ سابقة)، وطرابلس، وبلدته زغرتا، جارة طرابلس… بينما بالمقابل يذكر أسماء المدن الأوروبية صراحةً. هنا أجد أسبقيةً عنده للأنثروبولوجيا المقارِنة بين ثقافتين (غربيَّة وشرقيَّة) على الأنثروبولوجيا المونوغرافية الشرقية التي قدَّمَ في شأنها إنجازاتٍ دراسيةً لافتة.
– الاضمار الأكبر في الرواية يتعلق بالجانب الديني. فلا ذكر عنده للإسلام والمسلمين بالاسم، ولا للمسيحية والمسيحيين أيضاً. يتكلَّم على “جهاتٍ دينية متطرّفة” تنسف، تخطف، تمنع… من غير تحديد هوّيتها الدينية! ولا يدخل في الالتفاتة إلى النزاعات بين الأديان (وربَّما كانت نواة النص مكتوبةً قبل صحوة التمذهب الاسلامي النائم لقرون طويلة، ولكن ليست من غير مآسٍ ومجازر مستجدة متعاقبة ومتنقلة، ضمن البيئات الإسلامية. كما يتبدَّى الخوف على الحرية عنده في الخوف من “الاستبداد الشرقي”، ومظهرُه الاستنكافُ عن زيارة مدنه “الشرقية” والتفاعل معها… وتكون فرنسا في هذا المجال، في التقليد المسيحي اللبناني خصوصًا، وخارج وعي المؤلف/ الراوي، ملجأً من الاضطهاد، ملجأً مثالياً (الأم الحنون) بحريته، المعروفة عالميّا،ً حيث يلتقي الشرقيون المختلفون دينياً بأسهل وأسلس من لقياهم بعضهم البعض في بيئتهم الشرقية؛ وبطبيعته المحافَظِ عليها، وجمالِ مدنها (التي كتب عنها مقالاتٍ كانت السببَ في الشك بولائه للمستبد المسيطِر على دولته)؟
لقد خرج المؤلف / الراوي من فرنسا عائدًا إلى مسقط رأسه، ولكنَّ فرنسا لم تخرج منه، لأنها كانت دوماً فيه (تقول الاسطورةُ، والبعضُ يقول التاريخ، إن عائلة الدويهي، كما عائلة فرنجية وسواهما في زغرتا، كما عائلات إسلامية في طرابلس أيضًا، تتحدَّر من أصول بعيدة فرنسيَّة صليبية! أيكون المؤلفُ، كسواه كثر في بيئته “الشمالية” اللبنانية، ممَّن لم تسقط من لاوعيهم كلِّيةً هذه “الأساطير”؟
– الغريب، والأدهى والاخطر ربما، أن الزمن، بدلاً من أن يجعل هذه الروايات ممكنةَ السرد من غير إحراجٍ أو توتُّرٍ مصاحب، لا يزال يفاقم عوائقَ ورودِها التلقائي إلى الوعي، ويخنق حريةَ التعبير عنها! وهكذا تكون روايةُ الدويهي اتهاماً لا للمستبد الحاكم وحده، بل لمرحلةٍ تاريخية مستبدةٍ ايضاً! فالاستبداد لم يعد محصوراً برأس الهرم السياسي، بل توزَّعَ في سلطات “المجتمع” الذي يسمِّيه البعض، تفاؤلاً: “المجتمع المدني”!
– الراوي جانباً، وهو الذَكَرُ المركزي، عالَمُ الرواية هو بمجمله عالمُ نساء: من الأم ورانيا في الوطن (وحدهما يراهما دورياً كل اسبوع في معتقله “حصن الميناء”، كل واحدةٍ على حدة، في يوم محدَّد)،. فالأم تبقى بهية الحضور كمثالٍ متعدِّدِ المزايا والقيم: في صلابة إرادتها، ورقَّتها، وحكمتها التي ترافق بعضُ تجلِّياتها الحكَمية سيرةَ الراوي وتتلازم مع مصيره، مثل وصيَّتها له: “لا تخف من شيء، لأنَّ كل ما تخافه تقع فيه”، في مقدِّمة روايته، كما تتحقق حقيقة حكمتِها في آخر الرواية. ورانيا التي سلَّمَها أوراقَه الشخصية التي دوَّنها في المعتقل وترك لها حسمَ خيار نشر الأوراق التي آلت لأن تصبح فعلاً هذه الرواية! إلى آنا الفرنسية الحاضرةِ الأولى في الرواية، عن طريق الذكريات، مع غيابها التام عن حاضره المأزوم. آنا الحبيبةُ الأبدية، آنا المتلهفةُ لإبن من علاقتهما معاً، مع تأبيه وخوفه وتردُّده، حيث فجَّرَ هذا التلهُّفُ علاقتَهما إلى الأبد. وحتى المحقِّق الرسمي الأوَّل معه، في السجن، كان امرأةً هي الرائدة “هناء” التي “سلَّم عليها يداً بيد” عن معرفةٍ سابقةٍ من باريس، قكانت المظهرَ الأولَ للسلطة العليا الذي واجهَه في معتقله!
– في كل هذه الإحاطة يمكن دومًا تلمُّس بديلٍ أنثوي عن الأنا الذكورية!
– وفي الرواية أيضاً أطراف حكايات كثيرة عن الانتحار تشي بمخاوف فعلية شخصيةٍ منه، غيرِ معلنة، يماسُ الهاجسُ منه وخطرُه شخصَ الراوي نفسِه، والخوف من احتمال قربه من أقربين منه!
– وفي الرواية دوماً مجالسُ في مقاهٍ، كأنه يشي بلااستقرار (كما في “ميرامار” نجيب محفوظ، أو “نزل السرور” لزياد الرحباني…) حيث الحروب وأزمنتُها مفاصلُ كبرى غيرُ واضحة المعالم، تقتلع الأشخاص من الأرتخاء في دعة الأمكنة المكينة وترميهم في القلق واحتمال الأسوأ.
– الراوي هنا هو شبيه لسميِّ المؤلف، أنطوان روكنتان، بطل رواية جان بول سارتر “الغثيان”، الذي ترك فجأةً مهمَّة التأريخ (أو الأنثروبولوجيا البحثية، غير الميدانية، والأدب، كما في حال بطل رواية الدويهي) إلى البحث عن كنه وجوده، أو قلق وجوده الذي وجدَه أخيرًا، ربما، في كتابته مأساته؟ لقد جاء كتاب سارتر على مشارف حرب كبرى (عام 1938): فهل تكون “حامل الوردة الأرجوانية” على مشارف شيءٍ مماثل عندنا، يتراكم حشد من القرائن السوداء لتعزيز صدق هواجسه؟
– لقد “اختار” الدويهي لبطله، في آخر المطاف، “سجنًا” آخر بديلاً عن “حصن الميناء” البلا نوافذ؛ سجناً مختلفًا، فيه أكثرُ من نافذة، تلك النافذة المحبَّبة لديه التي دأب على إطلاق العنان لعينيه من خلالها لرؤية العالم ، وليمارس عبرها، أينما كان، عشقَه لمنظر المطر الهاطل، تتعانق على زجاجها حبيباتُه المتفرِّقة، وتتَّحد. المطر الذي يجافي، في لاوعيه، جفافَ عالمِ الصحراء الملازِمِ عنده لمدن الاستبداد الشرقي التي يكرهها، والتي أرعبَه تسللُ أحدِ نماذجها إلى عقر بلاده، ما جعل تيمةَ الرواية كابوسًا لا نهاية له، تخرق سوادَه، وتفضح بشاعتَه، ومضاتٌ من الذكريات ومن لقاءاته الحبيبتين:الأم ورانيا.
– ولئن كان الاختيار، في عُرف الفلاسفة، المؤشرَ الأسطع على وجود الحرّية، فإنَّ الاختيار الذي فُرِض عليه كان شاهدًا على رسوخ الاستبداد وتماديه في قمع وردة هذه الحرية ومسخها، ما حوَّل “حصن الميناء” (مقلوب “قلعة الحصن” الجبلية، الطبيعةِ البهيَّة!) إلى رمزٍ لمعتقل شعب بكامله ووطن، وأقفال لأبواب مستقبل. عرضُ الاختيارِ بين افتداء سلامةِ الجسد (من “معتقل بلعة الصحراوي” ذي الصيت المرعب) بإذلال الروح (في “سجنٍ” مقترَح تسهل فيه القراءةُ وتصعب فيه الكتابة إلى حدِّ الانسحاق!)، اختيار مفاضلة بين عذابَين. في انصياعه إلى رغبة المستبدّ، أَنزَلَ عن كاهله حِمْلَ ذكرياته، وطرقَ باب الآتي، واستبدل شرودَه الخيالي إلى هناك بقلقٍٍ دائم على هنا الحرية والطبيعة الخضراء.
– “حصن الميناء” هو أيضًا سجن داخلي. والسجون، مهما طال النزول فيها، تبقى نقيضَ الإنسان الذي يتميَّز بكونه كائن الحرّية الأوحد، ولا يمكنها أن ترقى إلى حيازة دعة الإقامة وغبطة ديمومتها. وسجنه الجديد هو سجن مؤقت: هكذا يقول الأمل، لأنه يحيى ويستمر في كنف الأمل بسقوطه، ويهوي مع انهيار المستبد الذي يدعمه. هذه الثقة بالانهيار الوشيك للاستبداد، الذي “شرَطَ” خيارَه “الاذلالَ المؤقت” وحسمّه، عزَّزت المبالغةَ في الرهانَ عليه، في وجدان المؤلِّف/الراوي، مشاهدُ “الربيع العربي” المزامنة لمؤلَّفه.
– إلاّ أنَّ الكلام المرسَل على هذه الرواية الجميلة، الكابوسية الموضوع والمشرِّعة نوافذها، مع ذلك، على فرح آفاق مفتوحة ، لا ينوب عن صفحاتها الماية والتسعين التي نسافر بها، برفقة راويها وشاعرها الممتعة، عبر الأمكنة والثقافات والأزمنة إلى عوالم عشق صوفي لحريةٍ لا يشعر بها – للمفارقة – كثيرون منَّا، ولا يقلقون بالتالي من الضمور المتمادي لمساحتها! إلاّ أنها تبقى، كما يقول هيغل، المعنى الوحيد لتاريخنا كبشر.